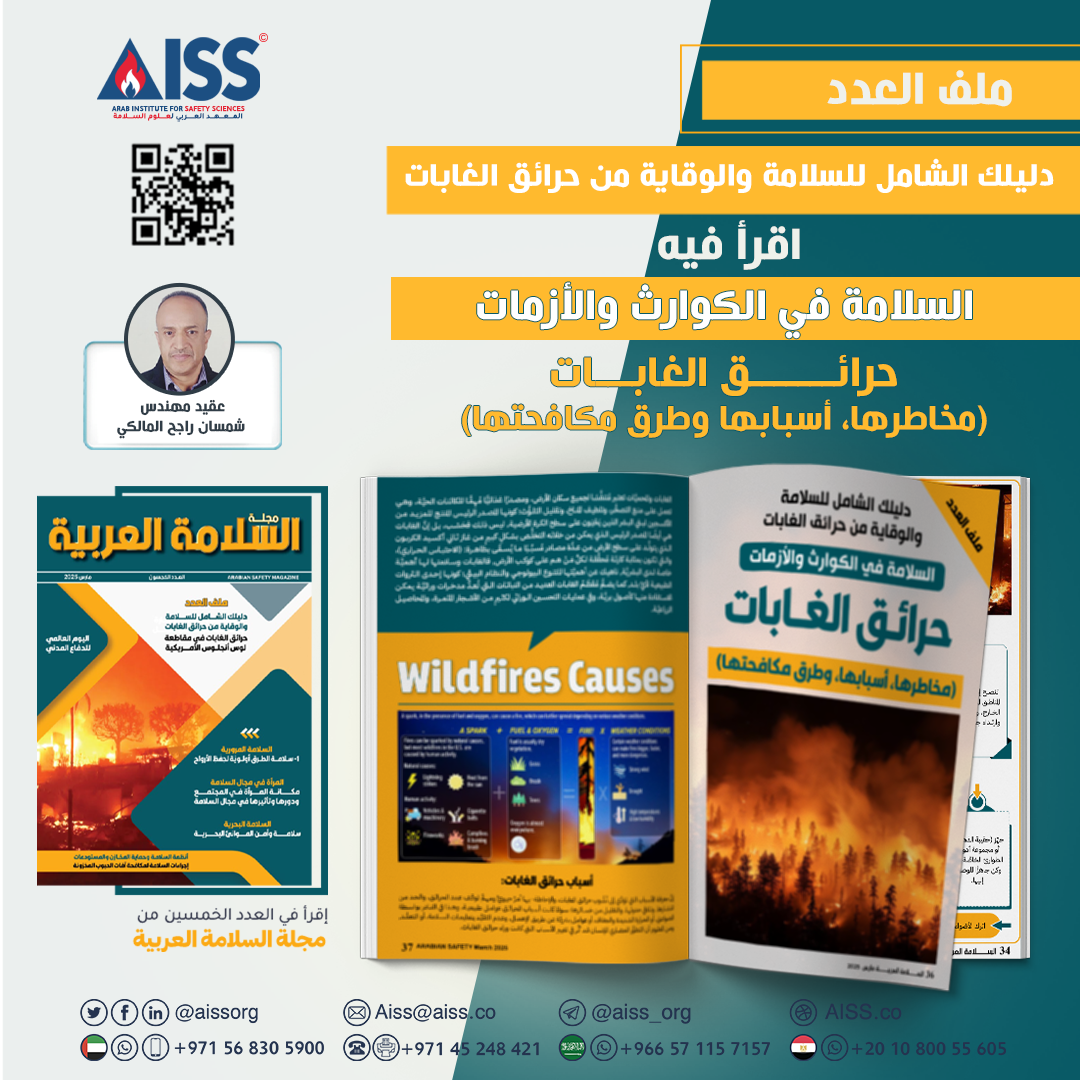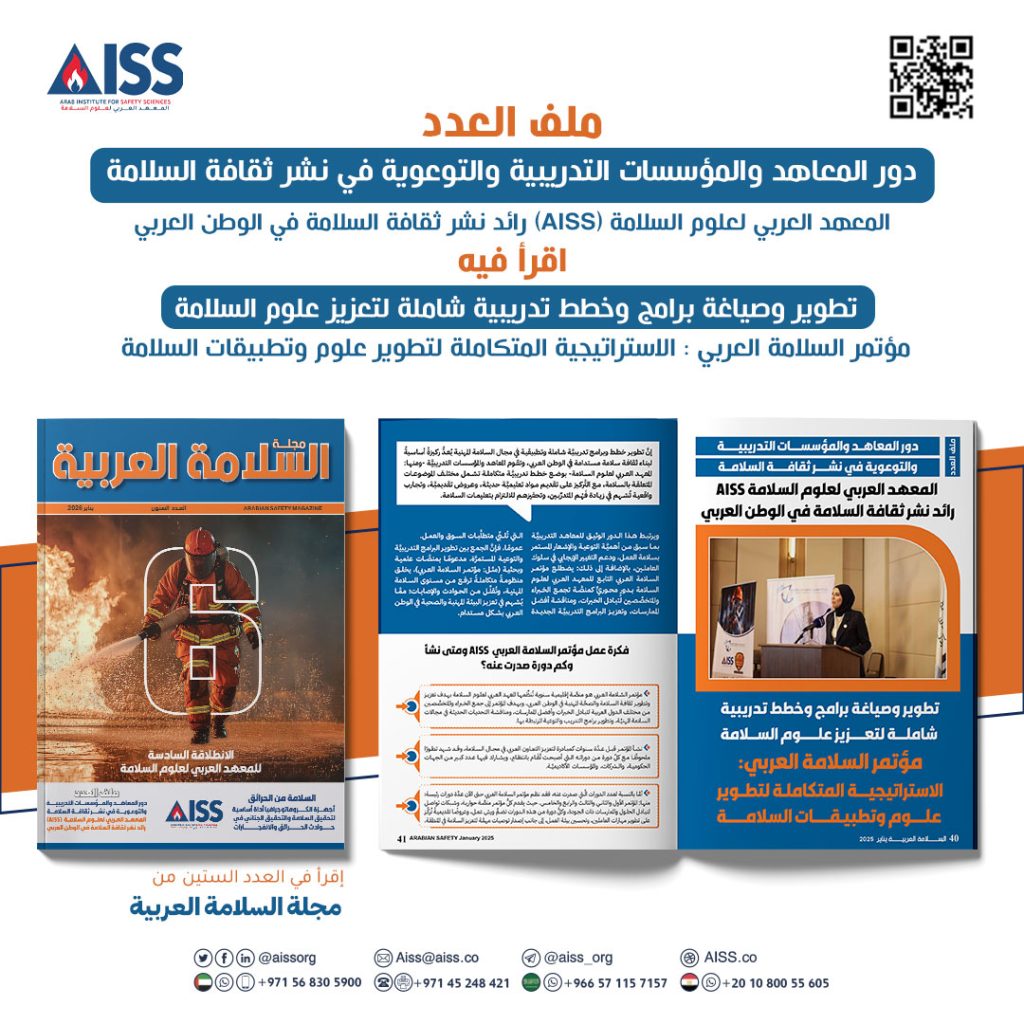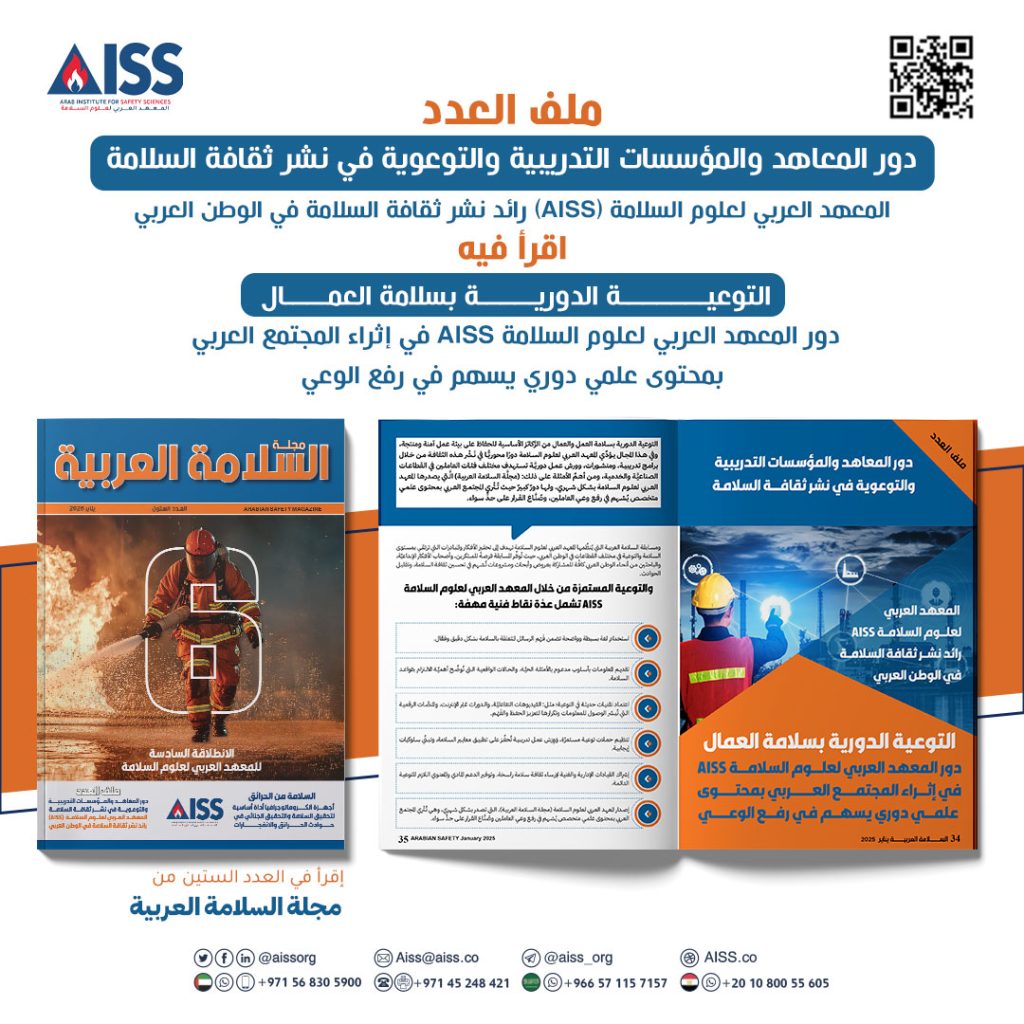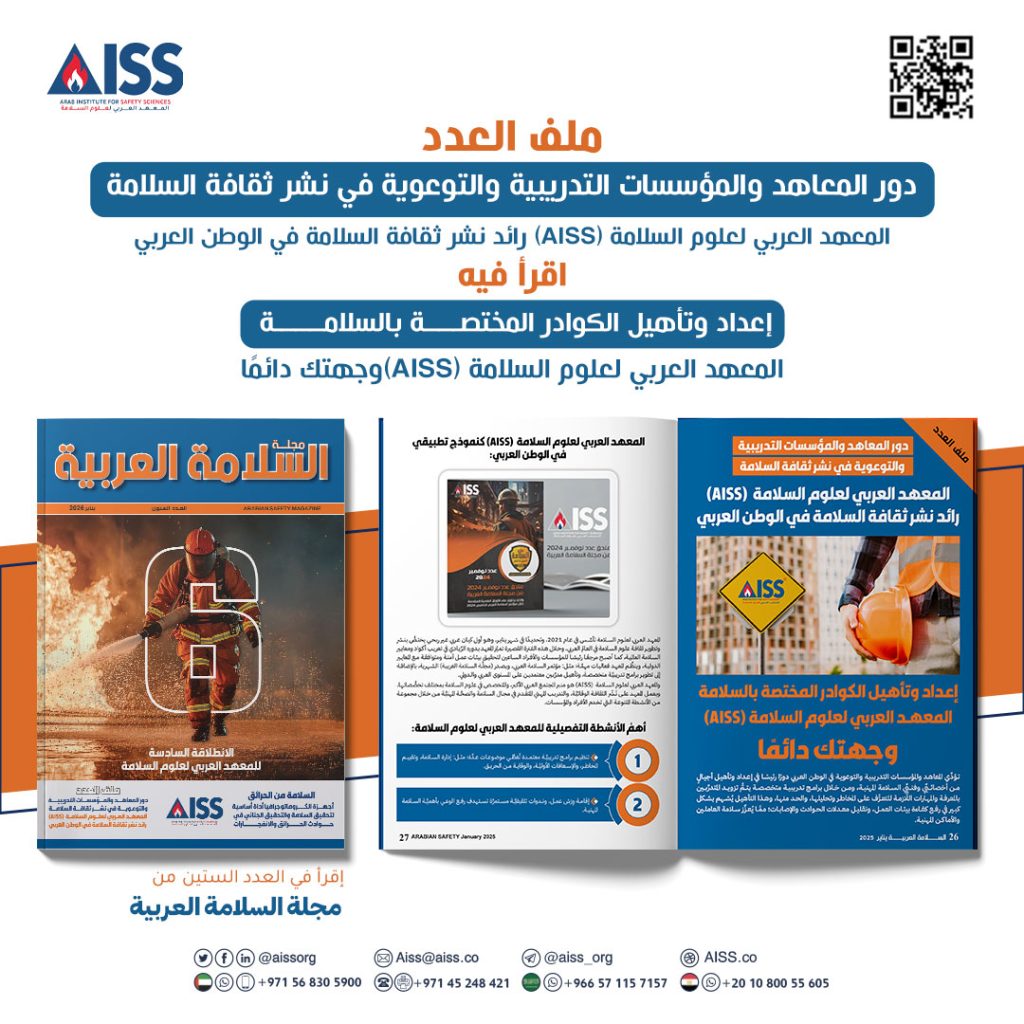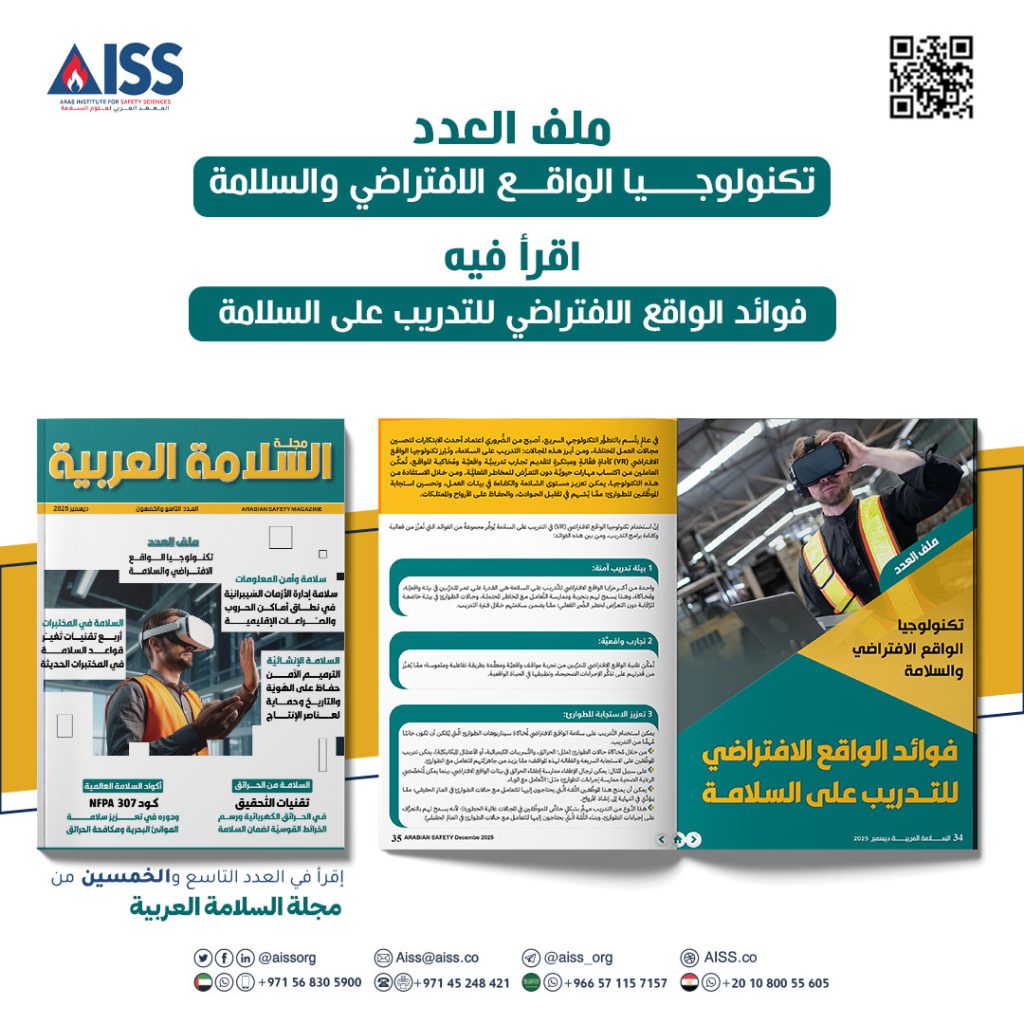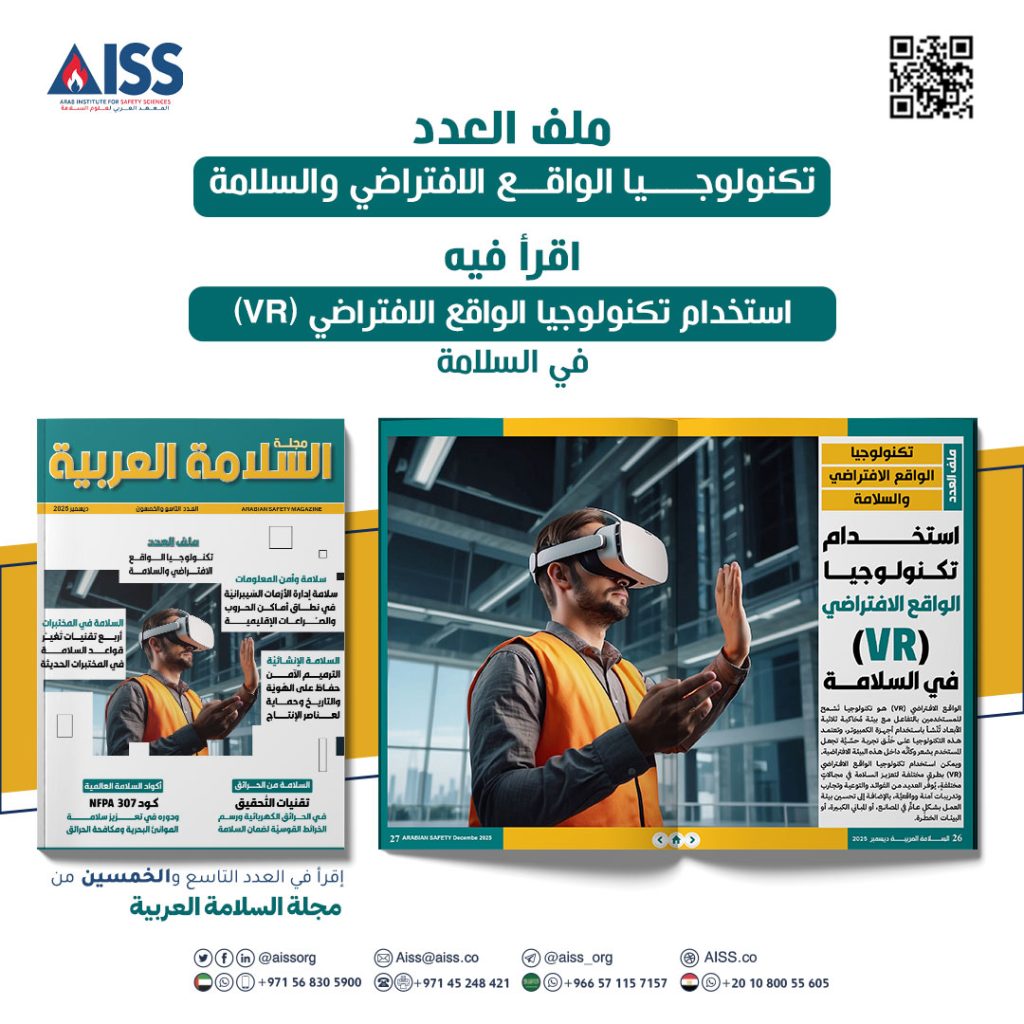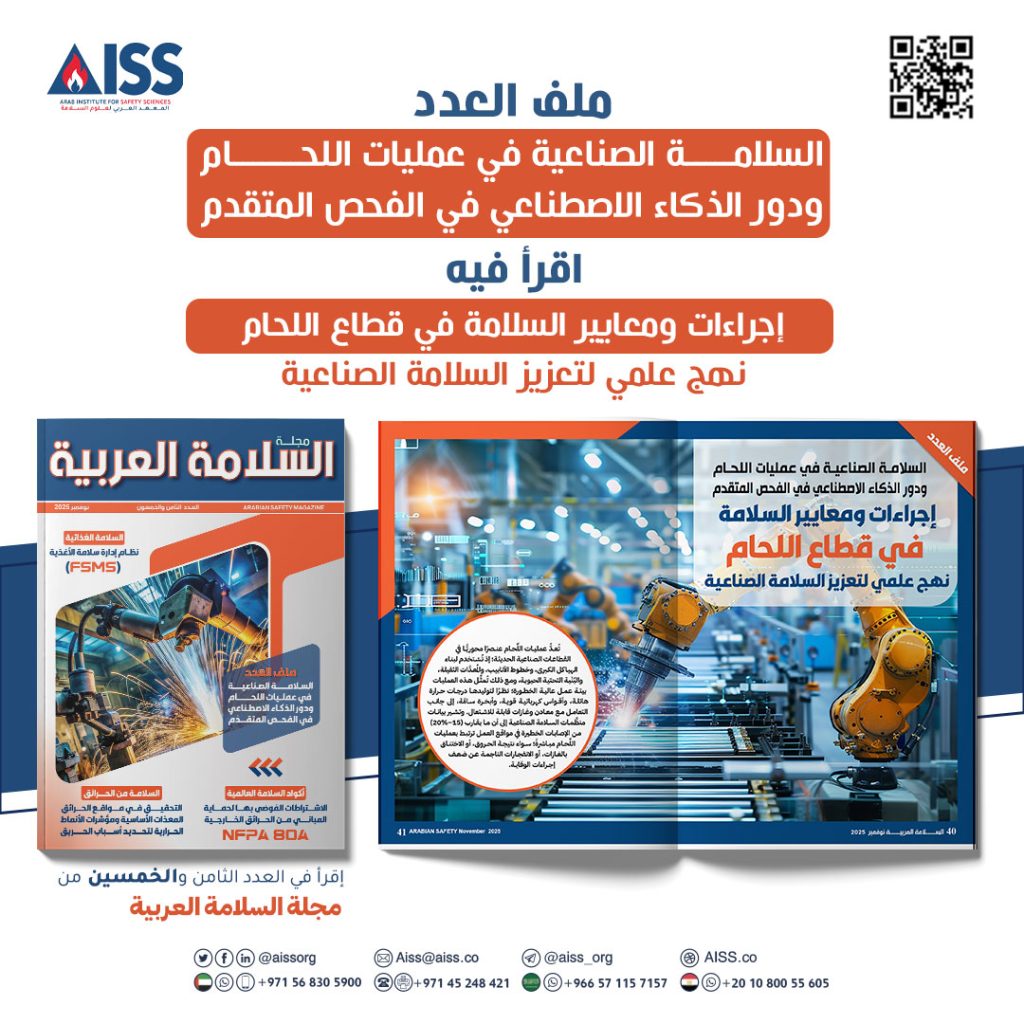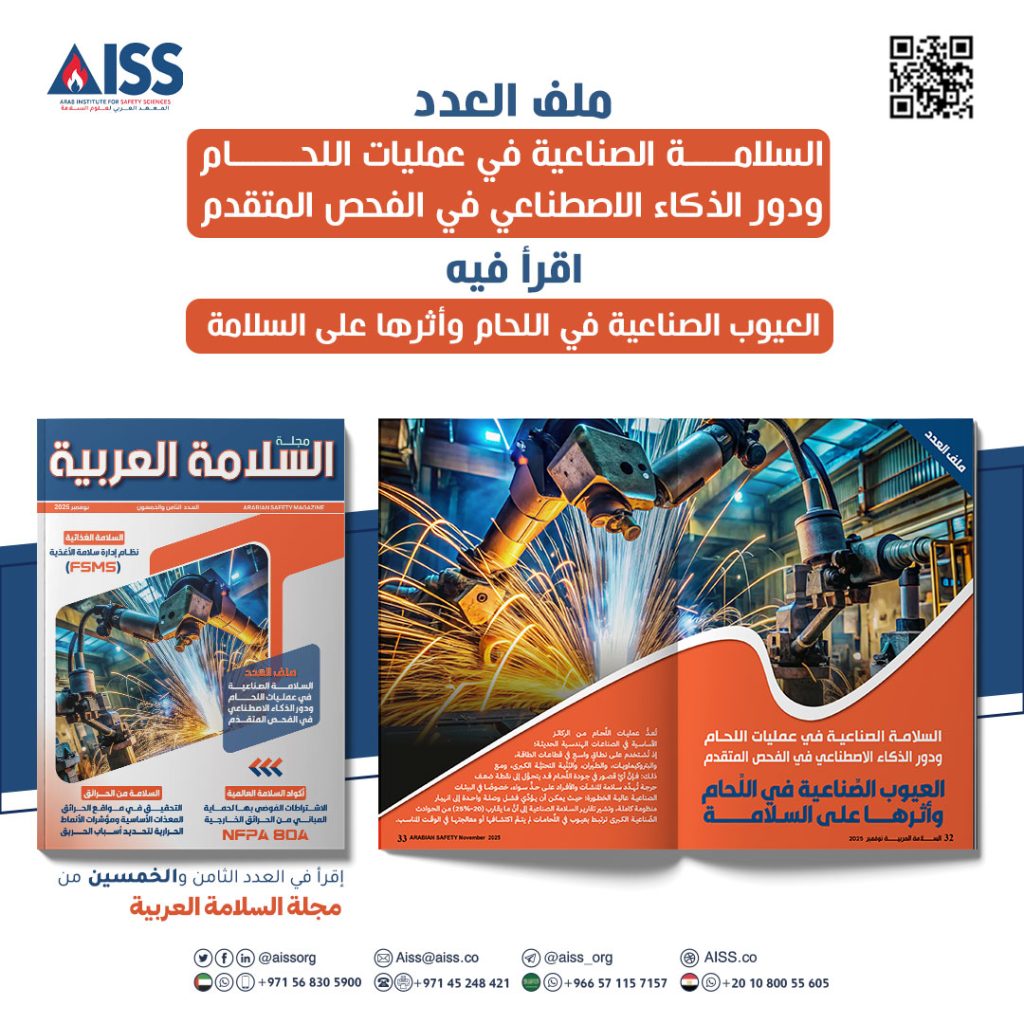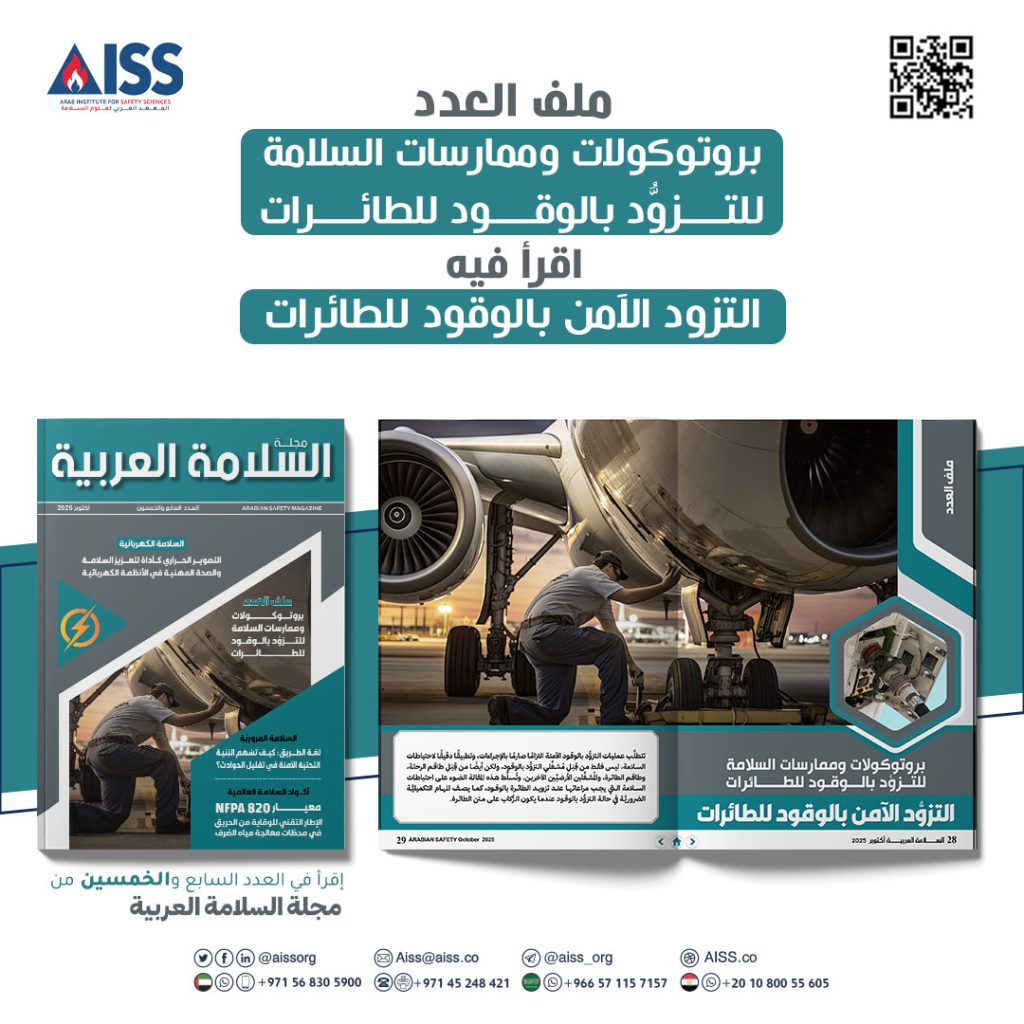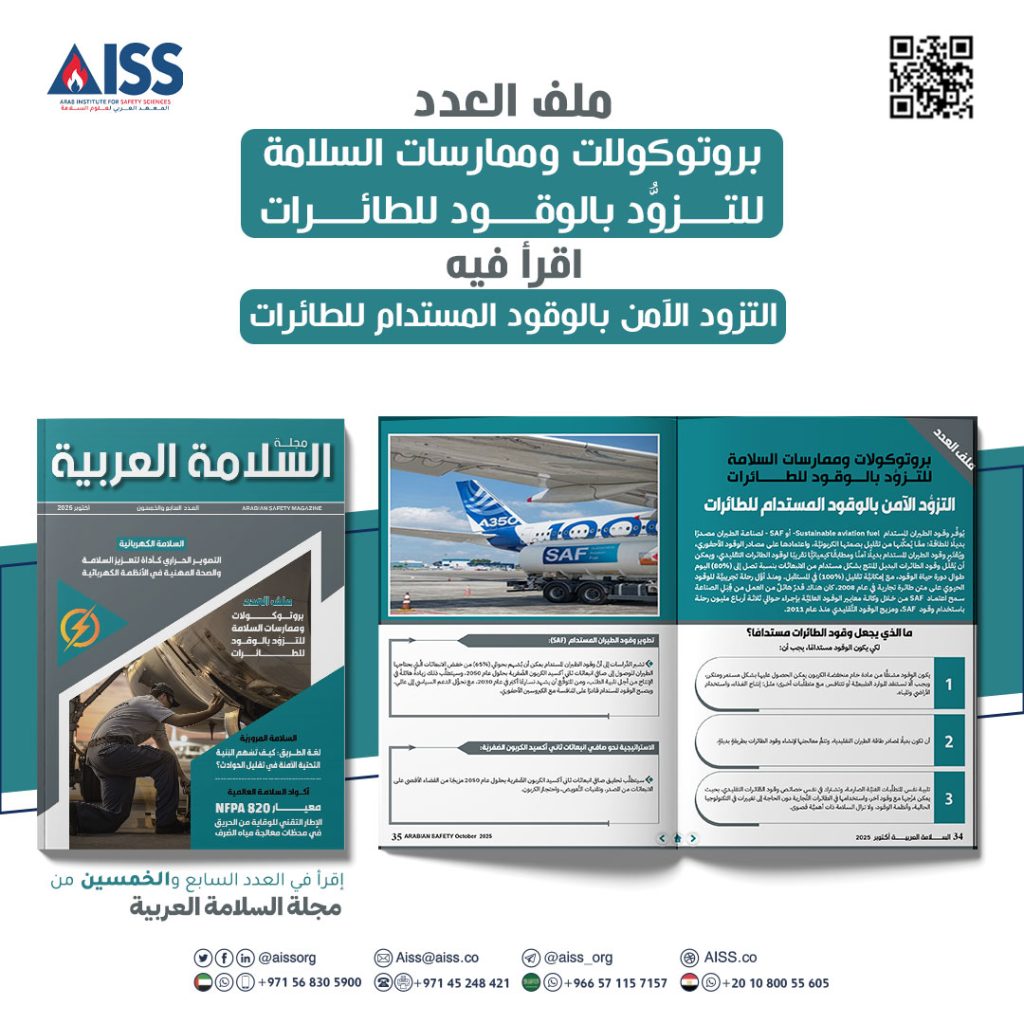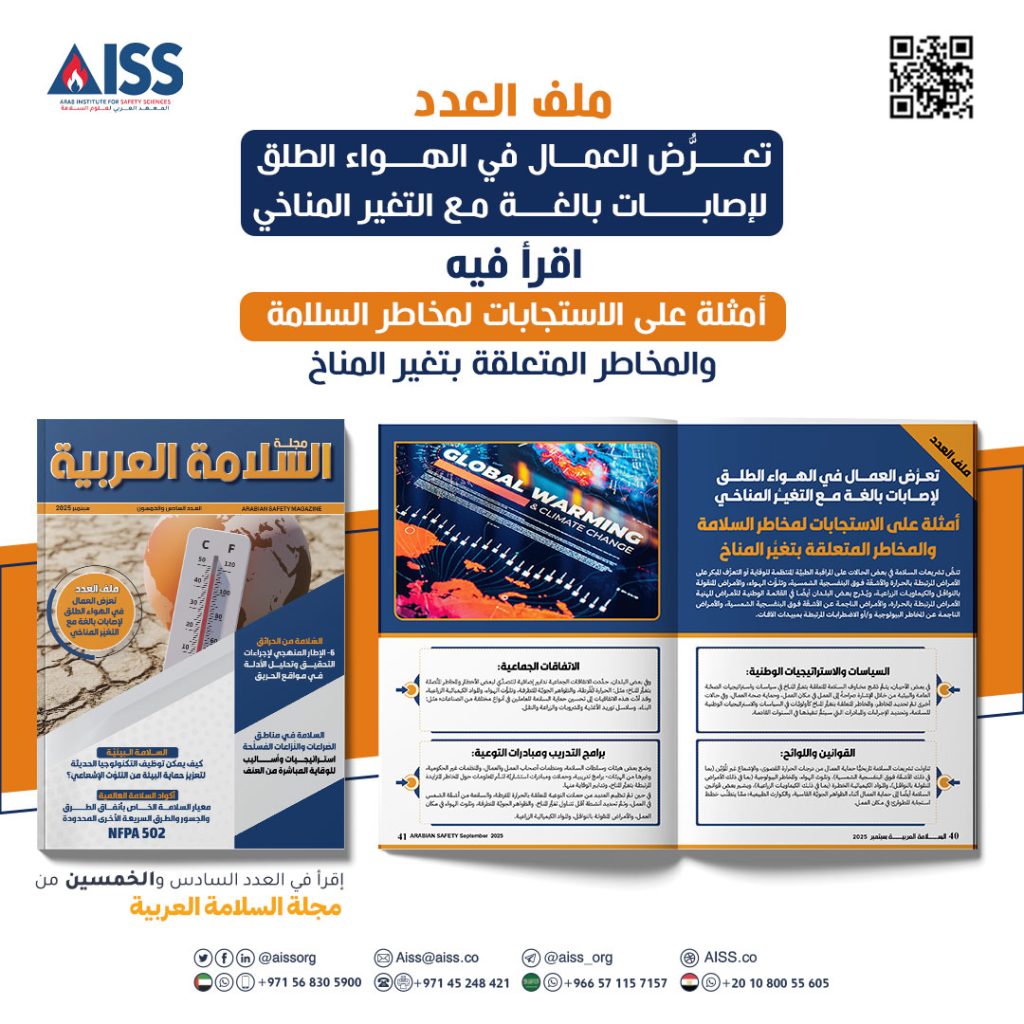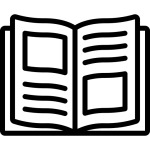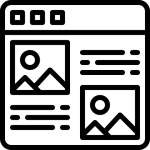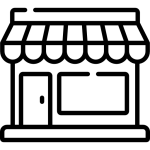دليلك الشامل للسلامة والوقاية من حرائق الغابات
مقدمة:
الغابات والمحميَّات تعتبر مُتنفَّسًا لجميع سكان الأرض، ومصدرًا غذائيًّا مُهِمًّا للكائنات الحيَّة، وهي تعمل على منع التصحُّر، وتلطيف المناخ، وتقليل التلوُّث؛ كونها المصدر الرئيس المنتج للمزيد من الأكسجين لبني البشر الذين يَحْيَون على سطح الكرة الأرضية, ليس ذلك فحَسْب، بل إنَّ الغابات هي أيضًا المصدر الرئيس الذي يمكن من خلاله التخلُّص بشكلٍ كبيرٍ من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتولَّد على سطح الأرض من عدَّة مصادر مُسبِّـبًا ما يُسمَّى بظاهرة: (الاحتباس الحراري)، والتي تكون بمثابة كارثة مُحقَّقة لكلِّ مَنْ هم على كوكب الأرض, فالغابات وسلامتها لها أهميَّة خاصة لدى البشريَّة, ناهيك عن أهميَّتها للتنوع البيولوجي والنظام البيئي؛ كونها إحدى الثروات الطبيعية لأيِّ بلد, كما يضمُّ مُعْظَمُ الغابات العديد من النباتات التي تُعدُّ مدخرات وراثيَّة يمكن الاستفادة منها كأصول بريَّة، وفي عمليات التحسين الوراثي لكثيرٍ من الأشجار المثمرة، والمحاصيل الزراعيَّة.

أسباب حرائق الغابات:
إنَّ معرفة الأسباب التي تؤدِّي إلى نُشُوب حرائق الغابات، والإحاطة- بها أمرٌ حيويٌّ ومهمٌّ لوقف عدد الحرائق، والحد من انتشارها، وتلافي حدوثها، والتقليل من خسائرها؛ سواءً كانت أسباب الحرائق عوامل طبيعية، وهذا في النادر بواسطة الصواعق، أو الحرارة الشديدة والجفاف، أو عوامل بشريَّة عن طريق الإهمال، وعدم التقيُّد بتعليمات السلامة، أو التعمُّد, ومن المعلوم أن التطوُّر الحضاري للإنسان قد أثَّر في تغيير الأسباب التي كانت وراء حرائق الغابات.
اليوم، مُعْظم حرائق الغابات – إن لم نقل كلها – يتسبَّب في اندلاعها الإنسان؛ سواء بشكل مباشر، أو بمُعدَّاته وأدواته بشكل غير مباشر, وأهمُّ الأسباب هي:
- ارتفاع درجة الحرارة، وتغيير المناخ.
- حدوث الصواعق، وحركة القطارات، وما ينتج عنها من شررٍ.
- الإهمال، وتَرْك المخلَّفات، وعدم وَضْعها في أماكنها المُخصَّصة لها.
- استخدام آلات القطع والقص، ومُحرِّكات الجرَّارات.
- التخييم، واستخدام آلات الطبخ.
- رَمْي المخلَّفات، وتَرْكها، ومن ضمنها قطع الزجاج، والَّتي تعمل على تسخين ما تحتها من جرَّاء أشعَّة الشمس عليها.
- بطريقة تخريبية متعمَّدة ومقصودة في إحداث الحرائق، والضرر بفعلها.
- الصيد، وحدوث الشرارة النارية نتيجة لإطلاق البارود.
- الرُّعاة، وما قد يفعلونه أثناء الرعي.
- حَرْق فضلات الغابات أو المزارع المجاورة.
- أعمال الاستثمار في إدارة الغابات، واستغلالها بشكلٍ مُسْتدامٍ، من قطع الأشجار، وتجزئتها، ونَقْلها.
- التدخين، ورَمْي أعقاب السجائر دون التأكُّد من انطفائها.
- وجود خطوط التيَّار العالي ذات القوة الكهربائية المرتفعة وسط الغابات، وبالقرب من الأشجار المرتفعة.
أنواع حرائق الغابات Types Of Forest Fires :
- الحرائق السطحيَّة – Surface Fire
- الحرائق الأرضية – Ground Fire
- الحرائق التاجية – Grown Fire
- الحرائق السطحية Surface Fire: هذا النوع من حرائق الغابات يحدث في الأعشاب الجافَّة، والأشجار والأوراق والحشائش والأشواك السطحيَّة، وهو أكثر حرائق الغابات انتشارًا.
- الحرائق الأرضية Ground Fire: هذا النوع من الحرائق يحدث في المواد العُضْوية المتحلِّلة على سطح الأرض من أوراقٍ متساقطةٍ، وأعشابٍ يابسةٍ وجافَّةٍ، وجذور الأشجار المُنْتهية, وينتشر هذا النوع من حرائق الغابات ببطء, ويمكن السيطرة على هذا النوع بسهولةٍ, وخسائره تكون بسيطةً إذا تمَّ السيطرة عليه في وقت قياسيٍّ.
- الحرائق التاجية Grown Fire: هذا النوع من حرائق الغابات يحدث في أعالي الأشجار، وينتقل من شجرة إلى أخرى باتجاه الرياح, ويُعدُّ من أخطر حرائق الغابات؛ لانتشاره وتسبُّبه في توسيع الحريق.
الإجراءات الوقائـيَّة، والإرشادات ضدَّ حرائق الغابات:
هناك مجموعةٌ من الإجراءات الوقائيَّة والاحترازيَّة؛ كالإرشادات والتعليمات والاحتياطات الأمنيَّة والتوعويَّة، والتي من شأنها التقليل والحد من حدوث حرائق الغابات:
- نَشْر الوعي عن إدارة الغابات، واستغلالها بشكل مستدام، عن الغابات، وأهميَّتها، وكيفيَّة المحافظة عليها، وجَعْلها خاليةً من الحوادث والحرائق عن طريق التعليم والتثقيف والإرشاد.
- دَعْم وتنفيذ القوانين واللَّوائح بصَرَامةٍ، والتي تضمن عدم حدوث أي حرائق داخل الغابات.
- مراقبة عمليَّات الاستثمار والزِّيارات، وإيجاد الاحتياطات المُشدَّدة في مَنْع التدخين، وعدم إشعال النار لأيِّ سَبَبٍ من الأسباب مهما كان, وحَرْق الفضلات في الوقت المناسب، وتحت المراقبة الشَّديدة من قِبَلِ المُختصِّين على السلامة في الغابات.
- المراقبة والإشراف على أعمال الصيد والرعي، وأعمال التخييم، وأي أعمال إنشائيَّة أخرى.
- تأمين مصادر المياه بعمل أنظمة صناعية؛ كالأحواض، والسُّدود، والبحيرات، وخزَّانات المياه، وتوزيعها بشكلٍ هندسيٍّ يسمح بضخِّ الماء منها بسهولة، والتزوُّد من هذه المصادر، وجعلها في أماكن قريبة من الممرَّات والطرقات.
- تسوية الأرض، وتثبيتها، وعمل الطُّرق والممرَّات الخاصَّة بسيارات وفِرَقِ الإطفاء وتأمينها, على أن تكون هناك ممرَّات أمان حول الغابات، واعتبارها حزامًا واقيًا، وشريط حماية، وجَعْلها فواصل طبيعيَّة تمنع انتشار النار.
- عمل أبراج مراقبة ومُجهَّزة بكاميرات كشف، وتوزيعها لتغطية جميع مناطق الغابة ضمن مربعات أو دوائر، والقيام بالدوريَّات التفتيشيَّة للتحرِّي عن الحرائق، واكتشافها في مراحلها الأولى، والإبلاغ عنها.
- وَضْع خطة طوارئ لتأمين وتنفيذ الإجراءات المُتَّبعة عند مواجهة الحرائق، وحالات الطوارئ، والاستعداد بتجهيز المتطلَّبات التي تَكْفُل سَيْر العمل دون تقصير, وهذه الاحتياجات والتجهيزات التي من الضروري توافرها عند الحاجة إلى مكافحة الحرائق؛ مثل:
-
- مُخيَّم ولوازمه من إسعافات أوليَّة وغيرها, ويمكن استخدام المُخيَّم كمركزٍ للإدارة والتوجيه.
- طعام وماء، ويُفَضَّل أن يكون الغذاء من الأطعمة الجافَّة والمُعلَّبة؛ تسهيلًا لنَقْلها وتَوْزيعها واستخدامها عند الاحتياج.
- وسائل تواصل، وأجهزة اتصال لاسلكيَّة متنقلة ويدويَّة لغرض التنسيق والتواصل، مع توفير خرائط تفصيليَّة.
- أجهزة ومضخَّات، وسيارات إطفاء، ومُعدَّات مكافحة حرائق الغابات.
- وسائل نَقْل من سيَّارات، وجرَّارات، وتراكتورات.
- آلات القطع؛ كالفؤوس، والمناشير بأنواعها المختلفة، والمجارف، والمحارق اليدويَّة، وغيرها.
- توفير آلات الإخماد، وإطفاء النار، ورش الماء، وعَرَبات الجر والحرث والتنظيف للعمل ضدَّ خط النار، ولحماية الممرَّات، وفَصْل المناطق عند اللُّزوم.
9-تأهيل وإيجاد فِرَقِ إطفاء الحرائق المتمرِّنة على جميع عمليَّات التحضير والإخماد، والتي تمَّ تدريبها تدريبًا جيدًا لمواجهة ومكافحة حرائق الغابات بكفاءة.
10-استخدام أنظمة تحليل وتقييم المخاطر قبل الحرائق، واستخدام نتائج البيانات التحليليَّة بعد الحريق، والاستفادة من البيانات المحدثة بصورة مستمرة، ووَضْع الخطط المناسبة للمواجهة والاستجابة السريعة لأيِّ طارئة أو كارثة تحصل في الغابات مستقبلًا.
أساليب وطرق مكافحة حرائق الغابات:
أ – الطريقة المباشرة: تُسْتخدم هذه الطريقة في الحرائق المحدودة والبطيئة في الانتشار، ويكون التركيز على الأطراف المشتعلة، ومنع زَحْفها وانتقالها إلى مناطق أخرى.
ويُراعَى في هذه الطريقة عمل خطوط فاصلة حول المناطق المحترقة للحدِّ من انتشارها، مع التركيز على الأماكن التي تتَّجه نحوها الرياح، وتخمد النيران برشِّها بالماء، وضرب ألسنة اللهب بفروع الأشجار الخضراء، أو الأقمشة ونحوها، على أن تُعْطى الأولويَّة لاستراتيجيات خط المواجهة للسيطرة على أطراف الحريق، أو أجزائه العليا المحترقة من الأشجار، وهو ما يُسمَّى بـ (الحرائق التاجية)، وبذلك يتحقَّق التقدم والسيطرة على الحريق.
ب – الطريقة غير المباشرة: وتُسْتعمل في حالة الحرائق الكبيرة سريعة الانتشار، وذات درجات الحرارة العالية، ويتمُّ عمل هذه الطريقة إذا ما اتَّضح عدم جدوى الطريقة المباشرة لإخماد الحريق، وتتمثَّل في مهاجمة رجال الإطفاء لمكافحة النار عند مقدمتها المتحركة بسرعة ألسنة اللَّهب التي تنتشر من موقعٍ لآخر، مع وجود مكافحةٍ مباشرةٍ للنار على جناحي المنطقة المشتعلة بشدَّة؛ ونظرًا لأنَّ معظم أشجار الغابات يتميَّز بكبر جذوعه وسيقانه؛ ممَّا يجعلها تختزن النار لفترة أطول، وتبدو من الخارج كأنها خامدة، وبفعل الرياح تشتعل مرةً أخرى، وهذا يتطلَّب بقاء الفِرَقِ المشاركة لفترة كافية في مواقع الحريق تحسُّبًا إلى اشتعال النيران من جديدٍ.
ج – الحريق المعاكس )المضاد(: طريقة من طرق الإطفاء غير المباشر، ويكون ذلك في الحرائق الكبيرة والخطرة؛ كالحريق التاجي والسطحي، والَّتي يتعذَّر مواجهتها من أرض مباشرة، وتتلخَّص طريقة الحريق المباشر بعمل خط نار )خط دفاع(؛ حيث يقوم رجال الإطفاء بقطع عددٍ من الأشجار وحرقها, ويُوجَّه الحريق باتجاه الحريق المراد إطفاؤه، فينتشر الحريق المعاكس نحو الحريق الرئيس بطيئًا، ثم تزيد سرعته بفعل تيار هوائي باتجاه منتصف المنطقة المشتعلة، وبعد فترة يقفز اللهب نحو تيجان الأشجار الملتهبة، وتنطفئ النيران بسبب انتهاء الوقود.
إجراءات مكافحة حرائق الغابات:
تتمُّ بالطرق المعروفة لإيقاف النار، وإن اختلفت الطريقة، فالمبدأُ واحدٌ:
- قطع الأكسجين عن الحرائق المشتعلة
: إمَّا باستخدام مادة الرغوة، والتي ستُشكِّل طبقةً لزجةً فوق النيران المشتعلة، وبالتالي توقف النار, أو باستخدام مادة البودر، والتي تُشكِّل سحابةً كبيرةً لتحجب الأكسجين عن النار, أو باستخدام مادة الرمل والتراب فوق الحرائق الصغيرة.
- امتصاص الحرارة (التبريد) من النار المشتعلة:
سواء كان استخدام هذا المبدأ عن طريق سيارات الإطفاء الخاصة بمكافحة حرائق الغابات، أو استخدام الطائرات الهليكوبتر، أو طائرات النقل، والتي تمَّ تخصيصها لحَمْل مواد إطفاء بكميات كبيرة وضخمة من المياه، أو المسحوق الكيميائي الجاف.
- التجويع، والحد من كميَّة الوقود:
بعمل فواصل ترابية لمحاصرة النيران، أو تجزئة النار المشتعلة إلى أجزاء وحرائق صغيرة, أو بإزالة المواد القابلة للاشتعال، وهي الأشجار والأعشاب، وكل ما هو قابل للاشتعال، وهذا يتمُّ بالاستعانة بمُتَطوِّعين (مُتدرِّبين مُسْبقًا على مكافحة الحرائق) من الجيش، والأمن؛ للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات تحت إمرة خُبَراء وقادة متخصصين في إطفاء حرائق الغابات.
- استخدام سيارات إطفاء مكافحة حرائق الغابات:
والتي غالبًا ما تكون متواجدةً في الغابات، وفي محيطها، مُتأهِّبةً بطاقمها لمكافحة حرائق الغابات.
- عمل طرق وفواصل ترابيَّة
لمَنْع انتشار الحريق باستخدام التراكتور، أو بطريقة يدويَّة باستعمال أدوات الحفر.
- الاستعانة بمظليِّين:
وهم رجال إطفاء مُدرَّبون على القفز بالمظلَّات لعمل خطوط فاصلة للحدِّ من الحريق، وعدم انتشاره، أو لعمل حرائق صغيرة، والسيطرة عليها، وإطفائها، وبالتالي تعتبر كحدٍّ فاصل, فعند وصول النار إلى هذه المناطق، لا توجد مادة وقود من أشجار وأعشاب تتغذَّى عليها لاستمراريَّة الاشتعال، وبالتالي يتوقف الحريق.
- استخدام الطائرات الهيلكوبتر أو طائرات النقل:
والتي تمَّ تخصيصها لحَمْل مواد إطفاء بكميات كبيرة وضخمة من المياه أو المسحوق الكيميائي الجاف؛ مثل: طائرات الإيرباص، والبوينغ، والطائرات العسكريَّة ذات الحمولات الكبيرة.
العوامل التي تساعد على انتشار حرائق الغابات:
هناك مجموعةٌ من العوامل التي تؤثر في سرعة انتشار النار، واستمراريَّتها في حرائق الغابات:
- سرعة الرياح واتِّجاهها، وهذا من أهمِّ العوامل الأساسية, حيث تعمل الرياح على تجفيف الأعشاب والأشجار، وتحويل الهواء الساخن، وارتفاع الحرارة، ونقل أَلْسنة اللهب من منطقة إلى أخرى، وبالتالي تزويد الحرائق بالأوكسجين ليستمرَّ ويتواصل إلى مناطق أبعد وأكثر مع اتجاه الرياح وسرعتها.
- كمية ونوع المواد القابلة للاحتراق, وبقايا القطع والفضلات، والمواد العُضْوية، والأشجار والأعشاب اليابسة، وحالتها جافَّة أم رطبة.
- طبوغرافية الأرض، وطبيعة الأرض وتضاريسها، وانحدارها، لها تأثيرات في انتقال الحرائق من منطقة إلى أخرى.
- الرطوبة النسبيَّة، وشدَّة حرارة الجو والأمطار، فعندما تقلُّ الرطوبة، يزداد خطر انتشار الحريق، والجفاف وقلة الرطوبة، ونسبة الرطوبة في الأشجار والأعشاب وجفاف الغطاء النباتـي.
- الوقود (كثافة المواد القابلة للاشتعال ونوعيتها)، فكلما كانت الغابات كثيفة ومتنوعة بأشجارها، كانت وفيرةً بالوقود الكافي لاستمرار الحرائق وانتشارها؛ لتنوُّع المواد القابلة للاشتعال وطبيعتها, فوجود عامل الحريق نفسه، وكمية النار وشدتها ومدى القدرة على السيطرة عليها وعدم الاستطاعة في إخماد النار أثناء مراحلها الأولى، يُشكل عامل مؤثر في استمرار حرائق الغابات.
6- المناخ ودرجة حرارة الجوِّ: هناك ما يُسمَّى بـ (فصول حرائق الغابات) عندما تكون حرارة الجوِّ مرتفعة، وخاصةً في ذروة فصل الصيف تحدث الحرائق، وتنتشر بسرعة في أوقات النهار أكثر منها في أوقات الليل.
التأثيرات السلبية لحرائق الغابات:
تُعْتَبر الحرائق من الأسباب المؤدية لتدهور الغابات، والإضرار بها، كما أنَّ لها العديد من الآثار السلبية البيئية والاقتصادية، ومنها ما يلي:
1- فقدان التنوُّع البيولوجي بانقراض النباتات، ونُفُوق بعض الحيوانات.
2- فقدان موارد الغابات الخشبيَّة، وزيادة رُقْعة التصحُّر.
3- زيادة نسبة ثانـي أكسيد الكربون في الغلاف الجويِّ بسبب انخفاض مصادر امتصاص الكربون في الطبيعة.
4- التأثيرات على المناخ، والاحتباس الحراري، واستنزاف طبقة الأوزون بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتسخين الهواء.
5- انخفاض الغطاء الحرجي، وتعرية التربة، والتأثير على إنتاجيَّتها؛ حيث إنَّ الحرائق تقضي على الكثير من الأعشاب والشُّجيرات، كما أنَّها تُقلِّل من مساحات الغطاء النباتـي.
6- استنزاف الحياة البريَّة، وربما فقدان مواطن الحياة البريَّة لبعض الكائنات.
7- فُقْدان سُبُـل العيش لبعض الأشخاص؛ إذ يعتمد الكثير من قاطني الغابات وجوارها على جمع منتجات الغابات النباتية والحرجية غير الخشبيَّة لكسب عَيْشهم.
8- تأثيراتها السلبية على النُّظم الأيكولوجية كافَّة.
9- التأثير الضار على التربة، وتغيير خصائصها، والقضاء على الآلاف من الهكتارات؛ كون الحرائق تُؤثِّر على تماسك التربة، وتقتل الكائنات الحيَّة الدقيقة، وتعمل على زيادة حامضيَّة التربة.
10- التأثيرات السلبيَّة، وانعكاساتها على جمال بيئة المحميَّات، وطبيعة الغابات والمراعي والحيوانات البرية والطيور.
11- التأثيرات السلبيَّة على جودة هواء التنفُّس، وتلوث المياه والبيئة.
12- تأثيرات ضارَّة على التجدُّد الطبيعي لأنواع الشتلات والشُّجيرات والبذور.
13- إحداث خسائر في الممتلكات وسُـبُل العيش؛ حيث تؤدِّي الحرائق إلى تدمير المنازل والممتلكات الأساسيَّة؛ ممَّا يُضْعف سُـبُل العيش، ويزيد من الفقر بين السكان المتضرِّرين, وإحداث ضررٍ في المحاصيل الزراعية، وانعدام الأمن الغذائي.
التقنيات الحديثة، ووسائل مراقبة الغابات:
من أجل المحافظة على الاستدامة الحيويَّة للغابات وسلامتها, لابد من استخدام وسائل وتقنيات حديثة تعمل ضمن برامج واستراتيجيات حماية الغابات وإدارتها، وتُشكِّل منظومة متكاملة لصيانة الغابات، والمحافظة عليها, ومن ضمن هذه الوسائل والتقنيات:
- الدوريات المُزوَّدة بالكاميرات الحرارية، والرؤية الليليَّة.
- أجهزة الاستشعار عن بُعْد، والموصولة بمركز الإدارة.
- بيانات وصور الأقمار الصناعيَّة، وتحليل تقلُّبات المناخ والطقس.
- استخدام الطائرات المُسيَّرة لتغطية المراقبة الميدانيَّة على مدار الساعة، وتغطية كامل المساحات المحميَّة ومناطق الغابات.
- أجهزة المسح الطيفيَّة، والرادارات الفضائيَّة.
- الأمن والحماية والمراقبة والتقييم المستمر للمحميات، وسد الثغرات الأمنيَّة، وإيجاد الحلول الملائمة والفعَّالة.
- برامج الحاسوب، ونُظُم المعلومات الجغرافية.
- أبراج المراقبة والتفتيش المُنظَّم.
- مستكشفات الدخان والحرارة.
إدارة كوارث حرائق الغابات:
أَوْلَى العديد من المؤسسات الدولية المَعْنيَّة بحماية البيئة اهتمامًا بالغًا ببرامج حماية البيئة واستدامتها، وإدارة المحميَّات والغابات بوضع إجراءات وأدلَّة توجيهيَّة وتنظيميَّة وتشريعيَّة، وسنِّ قوانين، وإبرام الاتِّفاقيات الإقليمية والدولية بهدف المحافظة على التوازن البيئي، وتوفير الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة في بيئة غنيَّة وخالية من التلوث، والحد من مخاطر تدهور البيئة، واختلال توازنها, ومن هذا المنطلق ظهر مفهوم إدارة وحماية الغابات من خلال:
1- الوقاية ومَنْع حدوث حرائق الغابات.
2- مراقبة الغابات بأنظمة الإنذار المبكر، والتنبُّؤ بارتفاع درجة الحرارة، واكتشاف الحرائق قبل حدوثها.
3- مكافحة الحرائق، وتقديم العون والمساعدة والإنقاذ، والاستجابة السريعة عند الطلب، وفي الوقت المناسب.
4- إجراءات ما بعد الحرائق من تحليل وتقييم الأداء، وتحسين وتطوير خطط الاستجابة السريعة في إدارة حرائق الغابات.
الخاتمة:
حرائق الغابات هي كوارث طبيعيَّة مدمرة، ولها آثار عميقة على النُّظم الأيكولوجية، ويمكن تعريف (حريق الغابات) بأنه: «حريق غير منضبط، وسريع الانتشار، يحدث في المناطق ذات الغطاء النباتـي الكثيف؛ مثل: الغابات أو الأراضي العشبيَّة»، وهناك أنواعٌ مختلفة من حرائق الغابات، كلٌّ منها يتميَّز بظروفه وأسبابه الخاصة.
وتشتعل الحرائق الطبيعيَّة عن طريق الصواعق أو الأنشطة البركانيَّة، في حين أنَّ الحرائق التي يُسبِّبها الإنسان تنتج عن أنشطة بشريَّة مختلفة، بما في ذلك السلوك غير المبالي، أو الحرق العمد، أو الممارسات الزراعيَّة، ويُعدُّ فَهْم الأنواع المختلفة لحرائق الغابات أمرًا ضروريًّا لتطوير استراتيجيات فعَّالة لمنع آثارها المدمرة، وإدارتها، والتخفيف من حدَّتها.